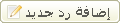جيل الحساسية الاجتماعية المفرطة
لم يعد مجردُ رأي عابر، أو تعليق بسيط، يمر دون أن يُفجِّر موجة من الانفعال أو الاستياء، باتت الكلمات تُفهم خارج سياقها، والنوايا يُساء تأويلها، والعلاقات تنهار لأتفه الأسباب، في ظل هذا الواقع المتأزم، يصف مصطلح "الحساسية الاجتماعية المفرطة" سلوكَ قطاعٍ واسع من الشباب، الذين يبدو أنهم يعيشون بحسٍّ مرهف إلى حدِّ الإرهاق، في عالَمٍ لا يرحم.
لكن هل نحن بالفعل أمام جيل هشٍّ نفسيًّا، أم أن ما نراه هو تطور طبيعي في وعي الأفراد بحقوقهم وحدودهم؟ هل الحساسية الاجتماعية المفرطة مرض اجتماعي، أم شكل جديد من أشكال التفاعل مع الواقع؟
بين الشعور والتهويل:
من الطبيعي أن يتأثر الإنسان بكلمات الآخرين، وأن يحزن أو ينزعج حين يُجرح أو يُهان، لكن المبالغة في التفاعل مع كل انتقاد أو رأي مخالف، والارتماء في دائرة التأثر السريع، قد يحوِّل أي نقاش إلى معركة، وأي نصيحة إلى هجوم شخصي.
جيل اليوم، وبفعل التنشئة الحديثة، والانفتاح الكبير على الفضاءات الرقمية، نشأ في بيئة تعظِّم من الفرد وتُعلي من شأن مشاعره، وأحيانًا على حساب المنطق أو الواقعية، فبات البعض يرفض أي صوت لا يتوافق مع قناعاته، ويعتبِر النقد الشخصي عدوانًا، ويخشى من المجادلة باعتبارها "تهديدًا نفسيًّا".
السوشيال ميديا ... المِرآة المكسورة:
لا يمكن إنكار أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا رئيسيًّا في صناعة هذا التوتر العاطفي العام، فبضغطة زرٍّ، يستطيع أي شخص أن يُعلن عن استيائه، أو يُشهِّر بمن أساء إليه – بحسب فهمه – دون حسيب أو رقيب.
التفاعل السريع، والردود الانفعالية، والبحث الدائم عن "التعاطف الجماعي"، كلها عوامل غذَّت ثقافة الحساسية الزائدة، بدلًا من أن يتعلم الشاب كيف يواجه المواقف أو يدير خلافاته، بات يلجأ إلى الهروب، أو الحظر، أو نشر منشورات غاضبة تُشير ولا تُسمِّي.
التربية الهشَّة تصنع فردًا هشًّا:
حين يكبر الطفل في بيئة لا تُهيئه لمواجهة النقد، ولا تُعلمه الفرق بين النصح والإهانة، يصبح أكثر عرضة للانكسار أمام كل رأي مختلف، كثير من الآباء - بدافع الحب - يبالغون في حماية أبنائهم، ويجنِّبونهم كل أشكال المواجهة، فينمو داخلهم توقع غير واقعي؛ أن يكون العالم لطيفًا دائمًا، ومتفهمًا دائمًا، ومؤيدًا دائمًا.
وهكذا، عندما يخرج الشاب إلى الحياة الحقيقية، ويصطدم بالمواقف، يُصاب بصدمة، ويُفسر القسوة الطبيعية في الواقع على أنها عدوان شخصي.
أين ذهب التحمل؟
سؤال جِديٌّ ينبغي أن يُطرح: لماذا لم نعد نتحمل؟
لا نتحمل كلمة ثقيلة.
لا نتحمل رأيًا مغايرًا.
لا نتحمل النقد حتى لو كان في مصلحتنا.
التحمل لا يعني التنازل عن الكرامة، ولا قبول الإهانة، بل هو فضيلة داخلية تُمكِّن الإنسان من التماسك، وتُعزز قدرته على إدارة مشاعره، بدلًا من أن تنفجر به أو عليه.
البعض يُدافع عن هذا "التحسس الجماعي" بأنه شكل من أشكال الوعي؛ وعي بالحقوق، ووعي بالذات، لكن الوعي الحقيقي لا يجعل الإنسان يهرب من كل اختلاف، ولا يُحوِّل كل خلاف إلى أزمة وجودية، الوعي الحقيقي هو القدرة على وضع المشاعر في مكانها، والتمييز بين الوقائع والانفعالات.
نحو تربية أكثر صلابة:
لا سبيل إلى تجاوز هذه الظاهرة إلا بتربية جيلٍ يتحمل، ويفهم، ويتعامل مع الحياة بمرونة وقوة، نحن لا نحتاج إلى قلوب باردة، لكننا بحاجة إلى عقول صلبة، قادرة على المواجهة دون قسوة، وعلى التفاعل دون تهور.
ولعل أول خطوة هي إعادة النظر في مفهوم التربية، من الحماية المطلقة إلى التهيئة الواقعية، ومن تجنب الألم إلى تعلم كيفية مواجهته.